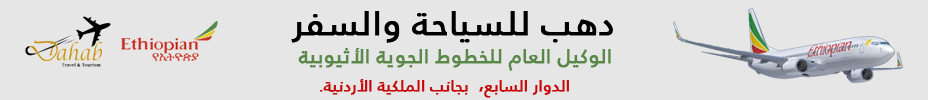- كتاب نيروز
- الأربعاء-2025-09-03 | 03:04 pm

نيروز الإخبارية :
بقلم سماح ابوخلف
إبن خلدون مؤسس علم الاجتماع وسلوكيات البشر ومسارات الأمم تتبع سقوط وميلاد دول وتمعن بمسار السلوك البشرى كتب ما يكفى من مجلدات لا تقرأ إلا للحصول على علامات النجاح ولا تفهم كمسيرة حياة وبداخلها الجواب على استفساراتك واهمها ماذا يحدث بنا من حكام ومحكومين وتوترات إقليمية
فى تفسير حقيقى للأزمه العربية والحكم
تظهر نظرية قيام العمران البشرى وسقوطه "المقولة الخالدة "الظلم مؤذن بخراب العمران "
ربط إبن خلدون أطوار الدولة بثلاثة أجيال فقط ، الجيل الأول يقوم بعملية البناء والعناية ، والجيل الثانى يسير على خطا الجيل الأول ، أما الجيل الأخير فيمكن تسميته بالجيل الهادم وكما للأشخاص أعمار طبيعية فالدول أيضاً أعمار وقد أعطاها 120 سنه كحد اقصى
"فبعدما كان الجميع يشترك في الحكم بشكل أو بآخر في الجيل الأول المؤسس للدول والحضارات، تنتقل إلى "انفراد الواحد وكسل الباقين عن السعي فيه، ومن عزّ الاستطالة إلى ذل الاستكانة، فتنكسر سورة العصبية بعض الشيء، وتؤنس منهم المهانة والخضوع".
بحسب إبن خلدون فإن الحكم العربى يقع ضمن هذا الجيل الثالث الذى تسقط فى عهدة الدوله وتنهار الحضاره .
النخب الحاكمه بكافه تسلسلها تحرص فى سلوكها السياسي والأخلاقي على الطمع والترف وينتقل الشعور بالمسئولية الاجتماعية والسياسية والعسكرية والاقتصادية إلى شعور آخر" النخبه"
تدوس الجميع من اجل مصالحها الخاصه وترفها الزائد ورفاهيتها وحدها دون غيرها
بل يضيف ابن خلدون "بل إنهم مع هذا يحاولون إظهار القوة من خلال احتكار السلاح والجيش، وذلك لقمع الناس إذا أرادوا الثورة ومواجهة استئثار هذه النخبة الحاكمة للسلطة والثروة"، ويتابع: "يلبسون على الناس في الشارة والزي وركوب الخيل وحُسن الثقافة، يموهون بها، وهم في الأكثر أجبن من النساء على ظهورها"
ويقول ابن خلدون "فإذا جاء المطالب لهم (أي إذا قامت الثورة عليهم)، لم يُقاوموا مدافعته، فيحتاج صاحب الدولة حينئذ إلى الاستظهار بسواهم من أهل النجدة، ويستكثر من الموالي (القوى الخارجية)، ويصطنع من يُغني عن أهل الدولة بعض الغناء، حتى يتأذن الله بانقراضها، فتذهب الدولة بما حملت".
أما عن صراعات الدول فقد تعامل إبن خلدون بواقعية تاريخيّة بأعتبارها حاله بشرية متكررة وطبيعية وكتب فى مقدمته
"اعلم أنّ الحروب وأنواع المقاتلة لم تزل واقعة في الخليقة منذ برأها الله وأصلها إرادة انتقام بعض البشر من بعض ويتعصب لكل منها أهل عصبيته فإذا تذامروا لذلك وتوافقت الطائفتان إحداهما تطلب الانتقام والأخرى تدافع، كانت الحرب وهو أمر طبيعي في البشر لا تخلو عنه أمة ولا جيل”.
وأضاف محللاً الإستراتيجية العسكرية "وصفة الحروب الواقع بين الخليقة منذ أول وجودهم على نوعين، نوع بالزحف صفوفا ونوع بالكر والفر، أمّا الذي بالزحف فهو قتال العجم كلهم على تعاقب أجيالهم، وأمّا الذي بالكر والفر فهو قتال العرب والبربر من أهل المغرب”
وهكذا اختصر اسباب الحروب لنوعين فقط (هما البغي والفتنة، أو الجهاد والعدل)
وبالنسبة لابن خلدون فإن الطابع الديني يفيد الجيوش بتقليل الخلافات بين أفرادها وتعزيز الشعور بالتماسك والرغبة في البذل والتضحية بدلاً من الخوف من الموت . فالهدف دينى ومن منا لا يرغب بالجنه
وهنا يبدء تاريخنا الحالى فى فلسطين تحديداً واتصالها بمقولة السياسيين "الحرب المقدسة"و"مبعوث من الرب "
"فى مهمه سماوية" كلها عصبية دينية
وتوراتية أنجليه حيث يتصدر المشهد رؤساء حكومات ودول يؤمنون بأنهم يخوضون حرب نهاية الزمان فى المنطقة العربية وأن جندهم فى مهمه سماوية ودماء العرب المسلمين هى ثمن نزول المسيح مرةً ثانية .
ولا ننسى النبؤات الدينية التى يلتف اليها كل الأطراف فى محاولة لإيجاد تبريراً للتضحية والموت . وللثبات اكثر فى ساحات المعركه، التى تعتبر حرباً دينيةً بأمتياز.
مازلت مصره ان التاريخ البشرى يكرر ويعيد نفسه زمناً بعد آخر ، والغلبة دائماً لصاحب الرساله الصحيحه والجنه مرهونه باختيارات الأفراد ضمن قوانين ربانيه لم تتغير فى زمن ما .