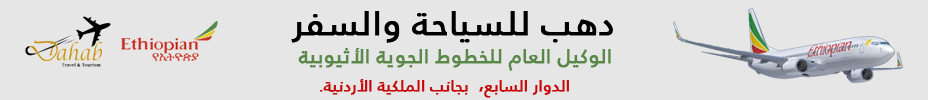- كتاب نيروز
- السبت-2025-08-23 | 02:03 pm

نيروز الإخبارية :
د. مثقال القراله
إن التجارب التنموية الناجحة في العالم لم تُصنع بالصدفة، ولم تولد من فراغ، وإنما وُلدت من رحم الرؤية الواضحة، والصرامة في التطبيق، والانضباط في إدارة المال العام، وربط الطموح بالعمل والنتائج. فسنغافورة التي تحولت من جزيرة فقيرة إلى مركز مالي عالمي، وماليزيا التي شقّت طريقها من اقتصاد يعتمد على المطاط وزيت النخيل إلى قوة صناعية وتجارية، وتركيا التي نقلت اقتصادها من حافة الأزمات المتكررة إلى مركز إقليمي للصادرات واللوجستيات، جميعها تشترك في حقيقة واحدة: أن الاستثمار لم يكن مجرد شعار، بل كان عقيدة وطنية، وأن الاقتصاد لم يُترك فريسة للبيروقراطية والتشتت، بل صيغ بمنطق "الدولة المستثمر" و"المجتمع المنتج" و"المؤسسة المحاسبة".
فالأردن، وهو يمتلك من الثروات البشرية أكثر مما يمتلك من الثروات الطبيعية، يقف اليوم على عتبة لحظة تاريخية تستوجب إعادة تعريف أولوياته. إن موقعه الجغرافي، الذي يتوسط أسواق الخليج والعراق وسوريا وفلسطين ومصر، ليس مجرد جغرافيا جامدة، بل بوابة استراتيجية يمكن أن تجعل من عمان والعقبة والكرك عقداً لوجستية إقليمية، تربط البحر الأحمر بالمتوسط، والخليج بأوروبا. وإن رأس المال البشري الأردني، الذي صُقل بالعلم والانفتاح والهجرة والاغتراب، هو رأس مال لا يقل قيمة عن النفط والغاز في دول أخرى، شرط أن يُوظف في مسارات إنتاجية وصناعية وتكنولوجية محددة.
وإذا كان في تجربة سنغافورة ما يضيء لنا الطريق، فهو قدرتها على بناء دولة تحولت إلى "حكومة للمستثمر" قبل أن تكون حكومة للموظف البيروقراطي. فقد جعلت النافذة الواحدة حقيقة، وليست شعاراً، وحددت للمعاملة زمناً، وربطت الأداء بالرقابة، وأظهرت للمستثمر أن الزمن ليس ملكاً لمزاج الموظف، بل هو حق للمشروع. ولو فعل الأردن ذلك، وجعل هيئة الاستثمار جهازاً نافذاً بسلطة إلزامية، وأطلق لوحة متابعة علنية تكشف أين يتعطل الترخيص ومن يعرقله، لأصبح الاستثمار في بلادنا منظومة واضحة لا مسرحاً للتخمين.
وفي التجربة الماليزية ما يُلهمنا أيضاً، فقد نجحت كوالالمبور حين قررت أن التصنيع لا يمكن أن يكون عشوائياً، ولا الاستثمار عاماً ومبعثراً. فاختارت قطاعات بعينها، ووجهت الحوافز بشروط قاسية، ربطتها بالتصدير ونقل التقنية والتوظيف، فجعلت المستثمر شريكاً في التنمية لا مجرد متلقي إعفاءات. وهذا بالضبط ما يحتاجه الأردن؛ أن يُعلن قائمة قطاعات استراتيجية محددة - الدواء الحيوي، السياحة العلاجية، الطاقة الخضراء، الخدمات الرقمية - ويقول للمستثمر بوضوح: "الحافز ليس هدية، بل عقد أداء"، فإذا وفيت بالتصدير والتوظيف والتدريب، نفيْنا نحن بما التزمنا، وإذا لم تفِ، سقط الحافز عنك كما يسقط الامتياز عن المقصّر.
أما تركيا فقد علّمتنا أن التصدير هو معيار الانضباط الاقتصادي، وأن الدولة التي لا تُصبح مصدِّرة حقيقية تظل أسيرة مديونيتها الداخلية. ففتحت أسواقاً، وبنت بنوكاً لدعم ائتمان الصادرات، وربطت سفاراتها بمؤشرات تجارية. وها هو الدرس الذي ينبغي للأردن أن يستوعبه، فدبلوماسيتنا الاقتصادية يجب أن تتحول من بروتوكول إلى مقاييس، من كلمات إلى عقود، ومن توقيع مذكرات تفاهم فارغة إلى صفقات تصدير حقيقية، مدعومة بتمويل وضمان ائتماني، لا وعود مؤجلة.
إن الأردن بحاجة إلى أن يحول مناطقه الاقتصادية الخاصة إلى منصات متخصصة على الطراز السنغافوري، حيث لا تكفي الإعفاءات بل يجب أن تُبنى الخدمات والبنى التحتية والتعليم المهني المصمم خصيصاً للمستثمر. وحين يصبح للعقبة هوية في البتروكيماويات الخضراء والهيدروجين، وللكرك هوية في الصناعات الطبية والرقمية، حينها يصبح لكل منطقة قصة، ولكل مشروع جدوى، ولكل حافز مردود.
كما أن الأردن بحاجة إلى أن يُدرك أن رأس المال السيادي ليس صندوقاً للادخار فقط، بل هو أداة تحفيز استثماري. تماماً كما فعلت سنغافورة عبر "تيمسِك" و"جي آي سي"، وكما فعلت ماليزيا في رأس المال الجريء، فإن إنشاء صندوق سيادي فرعي أردني، يطابق استثمارات القطاع الخاص في القطاعات النوعية، سيجعل الدولة شريكاً محفزاً، لا متفرجاً أو مانحاً لإعفاءات.
ولعلّ من أهم ما يجب أن يُعاد ترتيبه هو العلاقة بين التعليم المهني والقطاع الخاص. فقد فشلت معظم الدول العربية في هذا الميدان لأنها جعلت التعليم المهني مساراً ثانوياً، فيما جعلته ماليزيا عماداً للتنمية، فصممت البرامج بالتعاون مع الصناعة، وربطت التمويل بالتوظيف. وعلى الأردن أن يفعل الشيء ذاته، فيحوّل الشباب من طاقة مُعطلة إلى رافعة إنتاجية، ويجعل التدريب قسيمة تُدفع ثمنها فقط إذا أثمرت عن وظيفة مستدامة.
إن البنية التحتية في الأردن ليست بحاجة إلى مزيد من الموازنات المثقلة بالعجز، بل إلى شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص كما فعلت تركيا، حيث بُنيت المطارات والموانئ والطرق عبر عقود PPP صارمة، وزعَت المخاطر بعدالة، وجعلت من البنية أصولاً مدرّة لا أعباء متراكمة. وهذا ما ينبغي أن يحدث في الأردن: عقود شفافة، نماذج مالية واضحة، ومشاريع تطرح بجرأة على المستثمرين، في الطاقة، والطرق، والموانئ، والتخزين المبرد للأدوية والمواد الغذائية.
أما التحول الرقمي، فهو الذي يفتح باب الإصلاح الحقيقي، لأنه وحده القادر على أن يُقصي الفساد الصغير ويختصر زمن المستثمر ويجعل الإجراءات شفافة. ولن يكون الأردن في سباق المنطقة إذا لم يخلق هوية استثمارية رقمية، تربط الترخيص بالتأسيس بالضرائب بالقضاء التجاري، وتجعل المستثمر يُدير رحلته كاملة من شاشة هاتفه، لا من ممرات الدوائر.
وإننا إذا أردنا أن نربط هذا كله بمستقبل الطاقة، فإن الأردن يقف على عتبة ثورة الهيدروجين والأمونيا الخضراء، ويمتلك مساحات شمس ورياح قادرة على أن تجعله لاعباً إقليمياً في الطاقة الخضراء. ولكن الأمر يحتاج إلى سياسات تعرفة خضراء واضحة، وإلى ربط الحوافز بالقدرة على خفض الكربون للمنتجات، حتى يصبح الأردن مورداً لأوروبا والخليج في زمن تتسارع فيه معايير الاقتصاد الأخضر.
إن ما ينقص الأردن ليس العقول ولا الرؤى، بل الإرادة في تحويل الشعارات إلى عقود، والنوايا إلى مؤشرات، والمشاريع إلى نتائج. لقد أثبتت التجارب أن الدول التي تحترم الزمن والمال العام وتضع الحوافز في موضعها الصحيح، هي التي تخرج من أزمتها وتتحول إلى قصة نجاح.
والأردن قادر أن يفعل ذلك إذا انتقل من عقلية "إدارة الأزمة" إلى عقلية "إدارة الفرصة"، وإذا أدرك أن الاستثمار ليس باباً للترضية بل جسراً للتنمية، وأن الاقتصاد ليس أرقاماً جامدة بل مشروع وطني جامع. وعندها فقط، حين تُقاس السياسات بالنتائج لا بالكلمات، وحين تُصاغ القوانين بميزان الجدوى لا بميزان المزاج، يمكن للأردن أن يُطل برأسه شامخاً في الإقليم، لاعباً اقتصادياً فاعلاً لا متلقياً، ومصدّراً للنجاح لا مستورداً للتجارب.