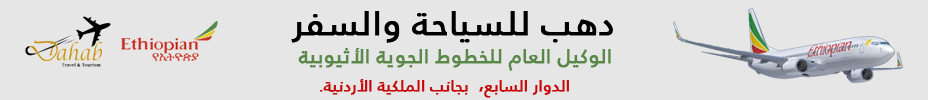- اقتصادية
- الأحد-2025-08-24 | 10:23 pm

نيروز الإخبارية :
كتب سلامة الدرعاوي
• حكومة أبو الراغب وقعت اتفاقيات مبادلة وشراء دين، لكن المديونية ارتفعت نهاية العام 2002 بمقدار 640 مليون دينار.
برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي شكل ضربة قاصمة لجهود الإصلاح المالي، وكان سبباً رئيسياً في زيادة الدين بعد دخوله في موازنة العام 2006.
تباطؤ نمو الدين في حكومة فيصل الفايز والتخرج من برامج التصحيح مع الصندوق.
نمو متزايد في المديونية بأكثر من 620 مليون دينار في حكومة البخيت العام 2006.
• حكومة الذهبي أبرمت اتفاقية باريس، وتم تخفيض الدين الخارجي بواقع النصف تقريباً.
العام 2009 شكل علامة سلبية فارقة في مسيرة الدين نتيجة الأزمة العالمية وبداية الربيع العربي وانقطاع الغاز وارتفاع أسعار الطاقة.
• حكومة الرفاعي أعادت ملف الدين إلى الواجهة بعد نمو كبير نتيجة مواجهة إفرازات تدهور الأوضاع الإقليمية وتنامي حركة الاحتجاجات الداخلية.
• بين 2009-2012، ارتفع الدين العام بواقع 8.2 مليار دينار نتيجة التداعيات السلبية في المنطقة والعالم.
حكومتا الطراونة والبخيت الثانية جمدتا عمليات الإصلاح ولم تتخذا قرارات مناسبة نتيجة تنامي حركة الشارع والتخوف من أي تطورات مستقبلية.
• حكومة النسور أضاعت أكبر فرصة مالية لضبط المديونية وتحقيق النمو بعد حصولها على المنحة الخليجية بقيمة 3.75 مليار دينار، وشهدت المديونية نمواً جنونياً.
حكومة الملقي شكلت استثناء لافتاً بتسجيلها أقل زيادة سنوية في الدين بدون الفوائد.
• ارتفاع بشكل كبير للمديونية في حكومة د. بشر الخصاونة، وبعض قراراتها أسهمت سلبا في انخفاض الإيرادات مثل "الجمارك".
حكومة د. جعفر حسان، رغم حداثتها، سجلت ثاني أقل زيادة في صافي الدين بدون الفوائد بمعدل 591 مليون دينار.
• الحكومة الحالية تنتهج نهجاً محافظاً لمحاولة كبح المديونية في ظل أزمات مستمرة، وتسير في اتجاه الحد من التوسع في الاقتراض الجديد.
• الدين العام من أكثر القضايا الاقتصادية حساسية، خاصة منذ العام 2012، في ظل بيئة إقليمية مضطربة اتسمت بالتقلبات السياسية والاقتصادية.
• أدى تصاعد مستويات الدين العام إلى التأثير على مستوى الثقة بين المواطن والحكومة، وفتح الباب أمام مراقبة شعبية متزايدة لكفاءة الإدارة المالية.
• بلوغ نسبة المديونية مستويات مرتفعة، مما وضع ملف الدين العام تحت المجهر، وأدخله دائرة النقاش العام بشكل غير مسبوق.
الدين ارتفع بنحو 1.8 مليار دينار بين 2004–2006، رغم وجود خطط وبرامج، إلا أن الخلل كان في التوازن بين الإنفاق والعائد، مع غياب أدوات تقييم فعالة لقياس الأثر الحقيقي للمشاريع المنفذة.
• الوضع الراهن يفرض إعادة النظر في منهجية التخطيط الاقتصادي، وربط الإنفاق التنموي بمؤشرات أداء واضحة تضمن تحقيق النمو من دون تحميل الاقتصاد أعباء إضافية.
لا يوجد موضوع اقتصادي يحظى باهتمام الشارع والمراقبين كما هو الحال بالنسبة للدين العام، الذي شغل الأردنيين على مختلف مستوياتهم، لما له من تداعيات بالغة الأهمية على جميع القطاعات.
هناك اهتمام أردني بالمديونية، وتخوفاته مشروعة ومبررة، وهي وليدة ذاكرة مأساوية حدثت في نهاية عقد الثمانينيات عندما انهار الاقتصاد الوطني العام 1989، وكان سببه الأساسي أزمة مديونية خطيرة عصفت به على مدى عقد كامل، وأدت إلى أزمة اقتصادية حادة انتهت بدخول الأردن في مسيرة برامج التصحيح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، التي استمر العمل بها لمدة 14 عاماً، ليخرج الأردن منها بأفضل مستويات مالية. لكن الانتكاسة حدثت بعد 6 أعوام، فعاد الأردن من جديد إلى الصندوق وبرامجه التصحيحية بعد تراجع ملحوظ في عمليات الإصلاح الاقتصادي الذاتي، وفشل الحكومات في اتخاذ الإجراءات الوقائية في أوقاتها، مما تسبب في تنامي الدين وتزايده بشكل كبير.
في هذا التقرير، سيتم رصد تطورات مستويات الدين العام، بالاستناد إلى بيانات وإحصاءات مالية تضمنتها النشرة المالية الصادرة عن وزارة المالية، لا تقبل الشك في مصداقيتها، وسيتمكن القارئ من الإجابة عن تساؤلاته كافة بخصوص الدين العام وتطوراته السلبية، إضافة إلى الإجابة عن السؤال الأكثر شهرة وانتشاراً بين الأردنيين، وهو: من هي الحكومة الأكثر استدامة في العقدين ونصف العقد الماضية؟.
وسيتناول التقرير معرفة دقيقة بالفرص التي أتيحت للحكومات من أجل ضبط المديونية والاستمرار في عمليات الإصلاح المالي، وكذلك الفرص التي أضاعتها حكومات أخرى نتيجة سلوكيات اقتصادية وإدارية غير رشيدة، أدت إلى تراكم الدين بشكل كبير ومن دون مبرر في بعض الحالات.
وسيتيح التقرير للقارئ إصدار حكم على سلوكيات الحكومات المالية بشكل مهني ومنطقي، مستنداً إلى بيانات وإحصاءات مالية دقيقة قد تفاجئ الغالبية العظمى من المتابعين. ولكن قبل الدخول في أعماق التحليل الفني في هذا التقرير، لا بد من توضيح بعض التغييرات التي ستمكن القارئ من الحكم العقلاني والمنطقي على ما سيخلص إليه التقرير من نتائج قد لا تعجب الكثير من المسؤولين الحكوميين، خاصة من رؤساء الوزراء ووزراء المالية.
المعيار الأهم في موضوع الدين هو تحديد دقيق لطبيعة الدين ومعرفة توجهاته، وهنا لا بد من تحديد معيار الحكم عليه من خلال تبيان الأسباب الحقيقية لأي عملية اقتراض حكومي، والتي لها وجهان لا ثالث لهما:
الأول: خدمة الدين السنوية من أقساط وفوائد، بمعنى أن أي حكومة ستواجه استحقاقات مالية بخصوص الدين ليس لها علاقة أصيلة بها. فعلى سبيل المثال، قامت حكومة الدكتور بشر الخصاونة بتسديد سندات يوروبوند في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2020 بقيمة مليار دينار استحقت في هذا التاريخ، وكانت هذه السندات قد استدانتها حكومة الدكتور فايز الطراونة العام 2012، والتي كانت أصلاً سداداً لسندات استدانتها حكومة البخيت الأولى العام 2007.
الثاني: الاقتراض الرسمي من أجل تمويل الاحتياجات التمويلية المختلفة للحكومة، سواء أكان لتمويل مشاريع رأسمالية، أو نفقات جارية، أو طارئة، أو غيرها من أوجه الإنفاق الرسمي.
وهنا تبرز أهمية هذا المعيار في كونه مؤشراً مهماً على سلوكيات الحكومة في إدارة المال العام، ومدى حصافتها في ضبط النفقات ذات الجدوى الضعيفة أو المعدومة، وتوجيه الاقتراض نحو المشاريع ذات القيمة المضافة العالية على الاقتصاد الوطني، وبما يسهم في رفد النمو المستدام.
سيتيح التقرير أيضا معرفة المحطات الفاصلة في هيكل نمو المديونية، والأسباب التي أدت إلى ما هي عليه الآن، وأين أخطأت الحكومات في التعامل مع هذا الملف الاقتصادي المهم، وكيف أسهمت بعض القرارات والخطط الحكومية في زيادة المديونية بطريقة جنونية نتيجة غياب الإدارة الرشيدة لملف الدين.
وسيجيب أيضاً: هل كان بالإمكان السيطرة على المديونية وضبطها في حدود اقتصادية آمنة؟
كما سيتناول التقرير تسليط الضوء على تداعيات التطورات الإقليمية والدولية على الأداء المالي للحكومات، وتأثير ذلك على هيكل المديونية. فكما أن هناك سياسات حكومية أسهمت في زيادة الدين، فإن هناك أيضاً آثاراً مالية وخيمة ترتبت على الخزينة نتيجة تداعيات الأزمات في المنطقة والعالم.
ويجب ألا نغفل في هذا التقرير الاستقصائي أن فرصاً عديدة أتيحت للحكومات الأردنية للاستمرار في الإصلاح المالي وضبط المديونية بشكل أكثر أماناً، لو أنها اتخذت القرارات المالية في أوقاتها الصحيحة.
مسيرة المديونية تبين أنها كانت 6.3 مليار دينار في العام 2002، وها هي تتجاوز 43.9 مليار دينار، ومن المرجح أن تقفل مع نهاية العام الحالي عند مستويات تفوق الـ46.3 مليار دينار، وهذا يعني مزيدا من التحوط وبناء استراتيجية وطنية لإدارة الدين، وزيادة الأخذ بمعايير جديدة للحد من نموه السلبي.
الدين بين الماضي والحاضر
يعد الدين العام، في نظر الكثيرين، أداة تلجأ إليها الحكومات لتلبية احتياجاتها التمويلية، غير أن هذا التصور لا يعكس الصورة الكاملة للدور الحقيقي الذي يضطلع به الدين العام، إذ يتجاوز كونه مجرد التزام مالي ليشمل أبعاداً اقتصادية وتنموية واجتماعية عميقة، تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الشامل. هذا التصور الشامل لمفهوم الدين العام، الذي لا يغيب، بلا شك، عن ذهن أي رئيس حكومة عند اتخاذ قرار الاستدانة، يؤكد أن الدين العام لا يختزل في كونه مجرد أرقام، بل يعد أداة تحليلية تمكن من فهم الواقع الاقتصادي، وقياس مدى قدرة الحكومة على التعامل مع الصدمات وإدارة مواردها بكفاءة وفعالية.
في الأردن، يعد موضوع الدين العام من أكثر القضايا الاقتصادية حساسية، خاصة منذ العام 2012، في ظل بيئة إقليمية مضطربة اتسمت بالتقلبات السياسية والاقتصادية. فقد أدى تصاعد مستويات الدين العام إلى التأثير على مستوى الثقة بين المواطن والحكومة، وفتح الباب أمام مراقبة شعبية متزايدة لكفاءة الإدارة المالية وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها. وقد تعزز هذا الاتجاه في ظل بلوغ نسبة المديونية مستويات مرتفعة، مما وضع ملف الدين العام تحت المجهر، وأدخله دائرة النقاش العام بشكل غير مسبوق.
وانطلاقاً من هذا الواقع، يسعى هذا التقرير إلى تقديم قراءة تحليلية معمقة لواقع الدين العام في الأردن، بالاعتماد على بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية، تغطي فترات زمنية امتدت عبر حكومات متعددة. ففي الأردن، قلما نجد نقاشاً فنياً متخصصاً حول موضوع الدين العام مع مراعاة مساره الزمني، بما فيه من أحداث متغيرة ومتوالية تترك، بلا شك، تأثيرها على مستوى المديونية، وهذا ما سأسلط الضوء عليه في هذا التقرير.
البداية منذ العام 2000
شكل العام 2000 محطة فارقة في مسار الدين العام، إذ كان آخر عام يشهد فيه الأردن انخفاضاً في مستوى الدين العام، الذي بلغ آنذاك 6.3 مليار دينار فقط.
في هذا العام، بقيت حكومة عبدالرؤوف الروابدة حتى منتصف حزيران (يونيو) 2000، قبل أن يتولى المهندس علي أبو الراغب المسؤولية، لتواصل حكومته نهجها الإصلاحي في إدارة الدين العام عبر تطوير أدوات إدارة الدين، وتحديث التشريعات ذات الصلة، وتنفيذ عدد من اتفاقيات مبادلة وشراء جزء من الدين الخارجي، رغم أن كل ذلك لم يمنع تسجيل ارتفاع طفيف في رصيد الدين العام مع نهاية العام 2001 بنحو 88.3 مليون دينار، وهو ارتفاع يمكن اعتباره محدوداً نسبياً بالنظر إلى القفزة الكبيرة في الدين العام المسجلة في العام 2002 بنحو 640 مليون دينار.
هذه القفزة أعادت ملف المديونية إلى واجهة الأولويات الاقتصادية، ودفعت حكومة أبو الراغب إلى تكثيف جهودها في إدارة الدين، وتحديداً الخارجي منه، من خلال توقيع اتفاقية مع الدول الدائنة الأعضاء في نادي باريس في شهر تموز (يوليو) 2002 لإعادة جدولة ما مجموعه 1.2 مليار دولار، تمثل أقساطاً وفوائد مستحقة حتى نهاية العام 2007، هذا إلى جانب توقيع اتفاقية مبادلة دين مع الجانب الفرنسي في شهر آذار (مارس) 2002 بقيمة 250 مليون فرنك فرنسي (ما يعادل 38 مليون يورو)، خصصت لأغراض استثمارية. هذه الخطوة، برأيي، هدفت إلى تحويل جزء من الدين إلى مشاريع تنموية تسهم في تخفيف العبء المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.
وقد شهد العام 2002 تنفيذ أولى مراحل خطة التحول الاقتصادي والاجتماعي (2002-2004)، وقد استندت هذه الخطة إلى ثلاثة محاور رئيسة: تعزيز الاستثمار العام، وتحفيز الاستثمار الخاص، وتطوير الإطار التشريعي، والمؤسسي، والرقابي، والتنظيمي. ومن أبرز سمات هذه الخطة أن الإنفاق المخصص لها لم يحتسب ضمن معادلة الموازنة العامة العام 2002، إذ جرى تمويلها من مصادر مالية خارج الموازنة، أبرزها عوائد الخصخصة، والمنح الإضافية خارج الموازنة، وقد أدخلت مشاريع برنامج التحول لدفعة واحدة في موازنة العام 2006، مما تسبب في نمو غير طبيعي في النفقات التشغيلية في خطة الدولة المالية التي تسبب بعدها في زيادة الاقتراض لتلبية هذه النفقات الطارئة، إضافة لاتفاقيات إعادة جدولة الديون. وقد بلغت الكلفة التقديرية للمشاريع المدرجة ضمن العام الأول من عمر الخطة نحو 200 مليون دينار.
استمرت حكومة علي أبو الراغب في إدارة شؤون البلاد حتى تشرين الأول (أكتوبر) 2003. وقد تزامنت هذه المرحلة مع أحداث إقليمية بالغة التأثير، أبرزها الحرب على العراق، وما نجم عنها من توقف إمدادات النفط إلى الأردن، وما زاد الأمر سوءاً الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط عالمياً وتراجع حجم المنح والمساعدات الخارجية. هذه التطورات ألقت بظلال ثقيلة على الاقتصاد الأردني، وأسهمت في زيادة الدين العام بنحو 200 مليون دينار في العام 2003، وارتفع بما يقارب 224 مليون دينار في العام 2004، ليصل الدين العام إلى حوالي 7.4 مليار دينار، ما شكل تحدياً إضافياً أمام الحكومة في سعيها لضبط وتيرة ارتفاع المديونية وسط بيئة إقليمية مضطربة، لا سيما وأن العام 2004 شهد تخرج الأردن من برامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي.
ومع مطلع نيسان (أبريل) 2005، انتقلت المسؤولية إلى حكومة فيصل الفايز، وخلال هذا العام، شهدت وتيرة الدين العام تباطؤاً إلى 93 مليون دينار، قبل أن يعاود الارتفاع في العام 2006 بأكثر من 620 مليون دينار في حكومة الدكتور معروف البخيت، التي باشرت مهامها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005، واستمرت حتى تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، وقد لعبت دوراً المنحة النفطية المجانية التي حصلت عليها المملكة بعد حرب العراق من الدول الخليجية الشقيقة لتلبية الكثير من التزامات الخزينة في ذلك الوقت، وتحديدا فيما يتعلق بفاتورة النفط.
السؤال المشروع هنا: هل نجحت البرامج الحكومية خلال الفترة 2002-2006 في كبح جماح المديونية، أم أنها أسهمت في تفاقمها؟ هذا السؤال يفرض نفسه عند مراجعة نتائج برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي 2002–2004 وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2004–2006؛ حيث ارتفع الدين العام خلال تلك الفترة بنحو 1.8 مليار دينار، رغم ما حملته من أهداف تنموية طموحة، إلا أن النتائج المالية تشير إلى خلل في التوازن بين الإنفاق والعائد، وغياب أدوات تقييم فعالة لقياس الأثر الحقيقي للمشاريع المنفذة. كما أن الاعتماد المفرط على الاقتراض، من دون ربطه بعوائد إنتاجية ملموسة، أسهم في تراكم الدين العام بشكل يثير القلق حول استدامة السياسات المالية المتبعة آنذاك. من هنا، تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في منهجية التخطيط الاقتصادي، وربط الإنفاق التنموي بمؤشرات أداء واضحة تضمن تحقيق النمو من دون تحميل الاقتصاد أعباء إضافية.
ولم يتوقف تصاعد الدين العام عند حدود الأعوام السابقة، إذ سجل العام 2007 زيادة إضافية تقدر بنحو 800 مليون دينار، ويعود، في جانب منه، إلى الارتفاع الحاد في أسعار النفط والحبوب والمواد الغذائية عالمياً. وقد انتهى العام بتسلم نادر الذهبي رئاسة الحكومة في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، ليجد نفسه أمام إرث مالي مثقل يستدعي مراجعة شاملة للنهج الاقتصادي المتبع، وإعادة تقييم جادة لجدوى البرامج السابقة التي لم تفلح في الحد من تفاقم الدين، رغم ما رصد لها من موارد وما روج لها من أهداف تنموية.
مع بداية العام 2008، انخفضت وتيرة ارتفاع الدين العام إلى نحو 446 مليون دينار، وهو ما يمثل تقريباً نصف الزيادة التي تم تسجيلها في العام السابق. وفي هذا السياق، تم تنفيذ اتفاقية مع نادي باريس، تم بموجبها شراء جزء كبير من الدين التصديري المستحق لدول أعضاء النادي، بقيمة بلغت نحو 1.7 مليار دينار، ما أسهم في إعادة هيكلة الدين وتعزيز الاستقرار المالي.
شكل العام 2009 محطة فارقة أخرى في مسار الدين العام في الأردن، وهو العام الذي تأثر فيه الأردن بتداعيات الأزمة المالية العالمية. وقد كان ذلك في عهد حكومة نادر الذهبي، قبل أن تنتقل المسؤولية في شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام ذاته إلى حكومة سمير الرفاعي، في ظل مرحلة اتسمت بتحديات اقتصادية متزايدة ألقت بظلالها الثقيلة على السياسات المالية في المملكة.
ولم تلبث هذه الضغوط أن ازدادت حدة مع انطلاق أحداث الربيع العربي، التي يعرفها الجميع بما حملته من اضطرابات إقليمية. وقد تجلى ذلك في ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، وانقطاع إمدادات الغاز المصري، ما ضاعف الأعباء المالية على الموازنة العامة، وأعاد ملف المديونية إلى واجهة المشهد الاقتصادي. وفي ظل هذه الظروف، ارتفع الدين العام خلال الفترة 2009-2012 بواقع 8.2 مليار دينار، وكانت ذروة هذا الارتفاع في العام 2012 بنحو 3.1 مليار دينار، وتعاقبت عليه ثلاث حكومات، بدءاً بحكومة عون الخصاونة التي انتهت ولايتها في نيسان (أبريل)، تلتها حكومة فايز الطراونة حتى تشرين الأول (أكتوبر)، ثم حكومة الدكتور عبد الله النسور، التي تولت المسؤولية في مرحلة دقيقة من المسار الاقتصادي والسياسي، مما يؤكد حجم التحديات الكبيرة في ذلك العام.
ما يمكن استنتاجه من هذا التحليل، أن الأردن فقد قدرته على خفض مستوى الدين العام منذ العام 2000، ليشهد ارتفاعات متسارعة، وإن كانت متفاوتة من عام إلى آخر، إلا أن الانفلات الحقيقي في ملف الدين بدأ فعلياً العام 2009، مع انتهاء مرحلة الانتعاش الاقتصادي ودخول الأردن مرحلة التباطؤ في ظل التحديات الإقليمية والعالمية التي يعلمها الجميع، وسجل ذروته في العام 2012.
وهنا يبقى التساؤل مطروحاً حول ما إذا كان من الممكن أن نكون أمام واقع مختلف لمسار الدين العام لو واصل الأردن برامجه الإصلاحية مع صندوق النقد الدولي من دون انقطاع؟ فالمحافظة على نهج الانضباط المالي كانت من شأنها أن تحد من تراكم الدين، الأمر الذي قد يكون أسس لقاعدة أكثر صلابة في مواجهة الصدمات في مرحلة لاحقة.
وفي سياق استكمال هذا التحليل، تبرز أهمية التوقف عند تطورات الدين العام بعد العام 2012، الذي سجل ذروة في مستويات ارتفاع الدين، وشكل نقطة تحول دفعت المملكة إلى العودة لبرامج صندوق النقد الدولي.
تطورات إجمالي الدين العام في الأردن منذ العام 2012
في أيار (مايو) 2012، تولت حكومة الدكتور فايز الطراونة المسؤولية، خلفاً لحكومة عون الخصاونة، في ظل ظروف اقتصادية صعبة. فقد واجهت الحكومة آنذاك تحديات كبيرة، أبرزها التباطؤ الاقتصادي الناتج عن تداعيات الأزمة المالية العالمية، إلى جانب انقطاع إمدادات الغاز المصري، وبدء موجات اللجوء السوري إلى المملكة وتنامي الحراك في المجتمع وزيادة الاحتجاجات، والتي عطلت من قدرة الحكومة على اتخاذ القرار المالي السليم. وقد أسهمت هذه العوامل مجتمعة في فرض ضغوط مالية متزايدة على الموازنة العامة، ما أدى إلى ارتفاع الدين العام بمعدل سنوي تجاوز 3 مليارات دينار، ليصل إلى نحو 16.9 مليار دينار.
وقد تزامن هذا المشهد الاقتصادي مع عودة الأردن إلى برامج التصحيح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك في شهر آب (أغسطس) 2012، من خلال برنامج الاستعداد الائتماني (SBA 2012–2015). وقد هدف البرنامج إلى ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الأردني والبيئة الاستثمارية. كما سعى إلى تقليص الفجوة التمويلية التي أثقلت كاهل الاقتصاد الوطني. ورغم التحديات الاجتماعية والسياسية التي صاحبت تنفيذ بعض الإجراءات، شكل البرنامج إطاراً عاماً للسياسات المالية والاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال تلك المرحلة.
ولم تدم حكومة الدكتور فايز الطراونة سوى حوالي خمسة أشهر، لتتولى بعدها حكومة الدكتور عبدالله النسور المسؤولية في تشرين الأول (أكتوبر) 2012، والتي شرعت، بعد نحو شهر من تشكيلها، في تنفيذ إصلاحات مالية جوهرية، تمثلت في إعادة هيكلة نظام الدعم الحكومي للسلع، بهدف توجيه الدعم إلى مستحقيه ومعالجة الاختلالات القائمة. وقد جاءت هذه الإجراءات في ظل الارتفاع الكبير في فاتورة دعم الطاقة، سواء للمحروقات أو الكهرباء، خلال العامين 2011 و2012، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للنفط وتراجع تدفق الغاز المصري. وقد أسهمت هذه الظروف، إلى جانب قيام الخزينة بتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) وسداد الديون المكفولة من قبل الحكومة لصالح الشركة، وتحمل تكلفة استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، وتمويل خسائر سلطة المياه، في رفع الدين العام بأكثر من 8 مليارات دينار خلال أقل من أربعة أعوام، وبمعدل سنوي يقارب 2.3 مليار دينار.
لكن، مع كل أسف، أضاعت حكومة النسور واحدة من أهم الفرص الاقتصادية التي لا تعوض بعد حصولها على منحة مالية من دول الخليج العربي بقيمة 3.75 مليار دينار وضعت بحساب خاص في البنك المركزي لتمويل مشاريع رأسمالية؛ حيث يرى الكثير من المراقبين أن الحكومة في ذلك الوقت لم تتمكن من توظيف صحيح للمنحة الخليجية من خلال تمويل المشاريع الرأسمالية في الموازنة وتقليل الاقتراض العام بذلك، لكن على العكس تماما ما حدث، فقد تم صرف المنحة الخليجية بشكل بعيد عن الموازنة، واقتراض بشكل كبير من دون الأخذ بعين الاعتبار لأموال المنحة، مما جعل حكومة النسور ثاني أعلى حكومة استدانة.
في حزيران (يونيو) 2016، تولت حكومة الدكتور هاني الملقي زمام المسؤولية في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار الإقليمي، إلى جانب الإغلاق شبه الكامل للحدود الأردنية مع سورية والعراق. وخلال فترة ولايتها، التي امتدت لنحو عامين، أظهرت البيانات المالية أن حكومة الملقي سجلت أقل معدل زيادة سنوية في الدين العام مقارنة بالحكومات الأخرى خلال فترة التحليل -حيث كان وزير المالية وقتها عمر ملحس- إذ بلغ متوسط الزيادة السنوية نحو 1.3 مليار دينار، رغم استمرار الضغوط المالية، وهو ما يضع حكومة الملقي في موقع متقدم نسبياً من حيث ضبط وتيرة نمو الدين العام. وقد واصلت هذه الحكومة نهجها الإصلاحي من خلال تبني برنامج اقتصادي جديد للفترة 2016-2019، مدعوم باتفاق مع صندوق النقد الدولي للاستفادة من تسهيل الصندوق الممتد، الذي تم توقيعه في آب (أغسطس) 2016، بهدف تعزيز الإصلاحات المالية والهيكلية، التي كان من أبرزها مشروع تعديل قانون ضريبة الدخل الذي لم يتم إقراره آنذاك.
● تسلمت حكومة الدكتور عمر الرزاز مهامها في منتصف حزيران (يونيو) 2018، وشرعت فور تشكيلها في إعادة النظر في مشروع قانون ضريبة الدخل وإقراره وفق الأطر الدستورية. وقد كان أمام هذه الحكومة تحديات كبيرة؛ أبرزها تداعيات جائحة كورونا، التي ألقت بظلالها الثقيلة على الاقتصاد الوطني، وتسببت في حالة من الانكماش الاقتصادي، ما فرض ضغوطاً غير مسبوقة على المالية العامة، وأثر سلباً على حصيلة الإيرادات الحكومية. ومع انتهاء ولاية حكومة الرزاز في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2020، ارتفع الدين العام بنحو 5.4 مليار دينار، بمعدل سنوي تجاوز 2.3 مليار دينار، ما يعكس حجم التحديات خلال تلك الفترة الاستثنائية.
في عهد حكومة الدكتور بشر الخصاونة، التي تشكلت في تشرين الأول (أكتوبر) 2020، وبقيت حتى منتصف أيلول (سبتمبر) 2024، كان أمام هذه الحكومة تحديات ثقيلة نتيجة استمرار تداعيات جائحة كورونا، وما أعقبها من ضغوط تضخمية عالمية رافقت مرحلة التعافي الاقتصادي، استدعت على إثرها دورة من التشدد في أسعار الفائدة عالمياً لمواجهة تلك الضغوط. وقد تزامنت هذه التحديات مع تأثيرات الحرب الروسية-الأوكرانية، ولاحقاً الحرب في غزة وما صاحبها من اضطرابات في البحر الأحمر، ما أسهم في تعقيد المشهد الاقتصادي والمالي.
حكومة د. بشر الخصاونة واجهت ظروفاً صعبة وتحديات جمة، لكن بالمقابل لم توظف عمليات زيادة القاعدة الضريبية التي تحققت في عهدها نتيجة الإصلاح الضريبي الذي قامت به دائرة ضريبة الدخل بشكل غير مسبوق في مواجهة المديونية وخدماتها، فقد استمرت وتيرة الاستدانة بشكل متزايد، ولا بد من التنويه، أيضا، إلى أن آخر أيام عمر الحكومة، وتحديدا بعد السابع من أيار (مايو)، شهدت الإيرادات المحلية للخزينة تراجعا حادا، في الوقت الذي جمدت الحكومة اتخاذ أي إجراءات إصلاحية مالية لتعويض الهبوط الحاد في الإيرادات نتيجة مواقف حادة في التحرك من قبل وزير المالية آنذك، ولم يتم إيجاد تفسير اقتصادي لها لغاية يومنا هذا، إضافة إلى أن قرار إعادة الهيكلة الجمركية الذي اتخذ في نهاية العام 2021، أثبت فعليا تداعياته الوخيمة على الإيرادات المحلية والصناعات الوطنية، والمحصلة كانت سلبية للغاية تمثلت في انخفاض الإيرادات المحلية الفعلي عن المقدر بأكثر من 900 مليون دينار.
وختاما، إدارة الدين الحكومي كانت متباينة من حكومة لأخرى، لكن كان واضحا أن هناك رغبة أكيدة لدى بعض الحكومات للتصدي لتداعيات زيادة المديونية، لكنها اصطدمت باستحقاقات مالية موروثة من حكومات سابقة، وترحيل مشاكل للأجيال المستقبلية، مما دفعها لمواجهة هذه الآثار السلبية بمزيد من المديونية الأعلى كلفة؛ أي دخلت هذه الحكومات في مسألة إدارة الدين أكثر من حل الإشكالية التي بات من المستحيل حلها من جذورها، كما يتصور البعض، مما يتطلب خطة وطنية واضحة المعالم ضمن قانون لإدارة الدين العام يقر من السلطة التشريعية ضمن الأسس الدستورية، يكون واضح المعالم والأهداف في السعي بخطوات واضحة ضمن فترات زمنية محددة تهدف أولاً وأخيراً لضبط نمو المديونية، ومن ثم العمل على تخفيضها بشكل متدرج يبدأ من خدمة الدين وانتقالا لمشاريع اتفاقيات الشراء والمبادلة لها ضمن صفقات ومشاريع اقتصادية وسياسية تعيد مستويات الدين إلى حالة الأمان الاقتصادي المنشود، وغير ذلك ستبقى الخزينة والاقتصاد يدوران حول نفسيهما في مواجهة المديونية. الغد