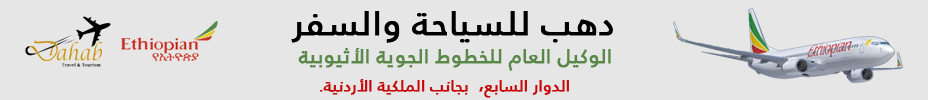- مقالات مختارة
- الثلاثاء-2025-07-15 | 12:48 pm

نيروز الإخبارية :
حين يتحدث الأردني والعراقي، لا نكون أمام حوار بين لهجتين فقط، بل أمام تصافحٍ طويل بين ذاكرتين، بين نبرة تُقال، وأخرى تُفهم، وبين لسانٍ وديّ ووجدانٍ مألوف حتى قبل تبادل الأسماء.
اللغة بين البلدين لم تكن يوماً حيادية. فهي محمّلة بتواريخ، بنُسَخٍ من الحنين، وبتقاطعاتِ نزوحٍ ورجوعٍ وتعلُّمٍ وتعايُش. العراق، صاحب واحدة من أعرق الحضارات اللغوية في المنطقة، هو الأرض التي نطقت أولى الأبجديات، وهو الذي أنجب مدرسة نحوية كاملة، وتدفقت من ضفافه مفردات الشعر، ومفاتيح البلاغة. ليس مجازاً أن نقول إن العراق علّم العرب كيف يُقال الشعر، وكيف تُحاك المجازات، وكيف تنبض اللغة بالحياة. هذا الثقل لم يتوقف عند الماضي، بل ظل حياً في لسان العراقي الذي يتحدث بحسٍ موسيقي، بجُمَل تُولد من رئة الذاكرة الثقافية قبل أن تنطقها الشفاه.
في الأردن، يجد العراقي لهجة مختلفة، أكثر اختصاراً، ذات نَفَس بدويّ حضريّ في آن، لكنها لا تنكر زائرها، بل تتوسع له. ومع مرور الوقت، تتشكل بين اللهجتين مساحة مشتركة: ليست هجينة بالمعنى السلبي، بل هجينة بالمعنى الخلّاق. يتعلّم الأردني من العراقي تعبيرات أكثر دفئاً، ويتعلّم العراقي من الأردني إيقاعاً مختصراً أكثر قرباً للواقع المُعاش. وما بين المزاح والكلام الجدي، يكتشف الطرفان أن بينهما ما يُقال دون حاجة إلى شرح، وأن اللغة جسد حيّ فيه نفسٌ مشترك.
وعبر السنوات، تحولت هذه العلاقة اللفظية إلى ما يشبه اللغة الثالثة: مزيج عفوي من لهجتين يتشاركان في الشارع، في السوق، في الجامعات والمناسبات. أبناء الجالية العراقية في الأردن لا يتحدثون كما وُلدوا في بغداد فقط، بل كما عاشوا في عمان أيضاً. وهذه ليست خسارة بل تحوّل طبيعي يدل على انفتاح اجتماعي يُصنع في الهامش، لا في المؤسسات.
لكن لهذه اللغة بعداً سياسياً أيضاً. فاللغة، كما يقول علماء الخطاب، تعكس ميزان القوى أحياناً، وتُعيد إنتاجه أحياناً أخرى. اللهجة العراقية حين تُستخدم في الإعلام الأردني، أو في المحادثات اليومية، لا تُستقبل على أنها غريبة، بل كمصدر نغمة مختلفة تُضفي عمقاً إنسانياً على المحادثة. وكذلك حين يستخدم العراقيون بعض المفردات الأردنية، فهم لا يقلّدون بل يضيفون إليها من مرونتهم التاريخية وقدرتهم على احتواء ما هو خارج عنهم دون أن يذوبوا فيه.
إن العراقي، حيثما حلّ، لا يكون مجرد ضيف؛ بل حاملاً لذاكرة ثقيلة ومشرّفة، ولغةٍ تنبض بأصوات الأنبياء والشعراء والباحثين عن وطنٍ يحترم لغتهم كما هم. في الأردن، تلك الذاكرة لم تُقابل بالريبة، بل في الغالب بالترحيب، وبمساحة اجتماعية سمحت لتلك المفردات أن تُزهر مجدداً.
في زمن التكتلات القاسية، تظل اللهجة المشتركة مساحة راقية للفهم، وتظل اللغة أرضاً مرنة يمكن أن نلتقي عليها دون شروط. لا السياسي هو من يصنع علاقة حقيقية بين بلدين، بل الناس حين يجدون أنفسهم يتحدثون معاً دون أن يشعروا بالغربة، حين يضحكون على نفس النكتة، ويتألمون من نفس العبارة.
في "شكو ماكو” كما في "شو الأخبار”، في "تدلل” كما في "تكرم”، هناك وطن صغير يولد في اللسان. وطن لا تُحدده الجغرافيا، بل الألفة.
بقلم د. شنكول قادر
رئيسة جمعية الإخاء الأردنية العراقية