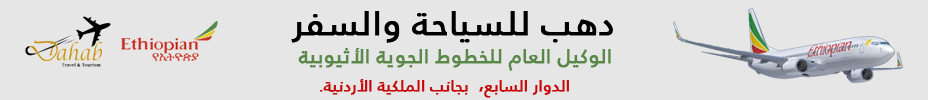- كتاب نيروز
- السبت-2025-07-19 | 11:15 am

نيروز الإخبارية :
بقلم راكان الزوري الخضير
"مقال تحليلي-توعوي"
تمهيد : ما من آفةٍ عصفت بوحدةِ الأوطان وأمنها مثل الطائفية. فهي تُحوِّل التنوّعَ الطبيعي إلى خندقٍ للاقتتال، وتَجعلُ الاختلافَ الديني أو المذهبي معيار الولاء والبراء بدل قيم المواطَنة.
وما إن تُطلَّ شرارتُها حتى يتصدّع جدارُ الدولة، وتُفتح الأبواب أمام الفوضى والتدخّل الأجنبي، ويغدو الانتماءُ الوطني مجرّد شعارٍ أجوف.
أوَّل حجرٍ في طريق الانهيار
يبدأ السيناريو غالباً بخطابٍ شعبويٍّ يستحضرُ مظالم حقيقية أو متخيَّلة، ويُلبِسُها ثوبَ "نحن” المهدَّدين و"هم” الظالمين. ما يلبثُ هذا الخطاب أن يتحوّل إلى فرزٍ اجتماعي داخل المدارس والجامعات والأسواق والمؤسّسات، فيتشظّى الولاء الجمعي إلى ولاءاتٍ فرعية متناحرة. عند هذه اللحظة بالذات تسقطُ الدولةُ من قلب أبنائها قبل أن تسقطَ مؤسّساتُها على الأرض.
دروسٌ حيّة من جوارنا
لبنان: حروب 1975-1990 أودت بحياة نحو 150 ألف إنسان، وخلّفت اقتصاداً منهكاً ونظاماً سياسياً طائفيّاً ما زال يعيد إنتاج الأزمات.
العراق بعد 2003: النزاعات السنّية-الشيعية مهّدت لتفتيت المجتمع وصعود تنظيم "داعش”، ولا تزال تُقوّضُ الاستقرار وتُضعفُ التنمية.
سوريا اليوم: على الرغم من انتهاء الحرب رسميّاً، اندلعت هذا الشهر مجازر في السويداء راح ضحيّتها مئات المدنيين، مع تقاذفٍ للاتهامات بين الفصائل المسلَّحة والجيش وأطرافٍ إقليمية، وعاد شبحُ التدخل الخارجي ليزداد حضوراً.
تُظهر هذه الأمثلة بجلاء أن الطائفية لا تتوقّف عند حدودِ خسائر بشرية هائلة، بل تُنتج فراغاً سلطويّاً تستغله قوى متطرّفة لتعيدَ تدوير العنف باسم "حماية الهوية”.
الدوافع والعوامل المغذِّية
1. الجهل التاريخي والديني: تَغيب القراءةُ النقدية للتراث، فيُستدعى الصراع القديم بلا سياقٍ أو ضابط.
2. تسييس الهُويات: نخبٌ سياسية تجعل الطائفة وسيلةً لحشد الأصوات أو ابتزاز الخصوم.
3. التدخل الخارجي: قوى إقليمية ودولية تُغذّي الانقسام لمدّ نفوذها أو بيع السلاح أو ابتزاز الموارد.
4. اختلال العدالة: حين يشعرُ مواطنٌ أن انتماءه مذهبيّاً هو بوابته الوحيدة للوظيفة أو الأمان، فإن الولاء للدولة يضعف بالضرورة.
الآثار المدمِّرة
تفكّك النسيج الاجتماعي: تتحوّل علاقات الجوار إلى علاقة ريبةٍ وخوف.
شلل الدولة: تُقسَّم المؤسسات أمنياً وإدارياً على أسس طائفية، فينهار الأداء العام.
نزيف العقول والاستثمار: يفرّ الكفاءات، ويُحجمُ رأس المال عن ضخّ المشاريع.
استدعاء الوصاية الخارجية: يصبح "حماة الطوائف” ذريعةً لتدخل عسكري أو سياسي طويل الأمد.
خارطة طريقٍ للتحصين والعلاج
1. إعلاء مبدأ المواطَنة
صياغة دستورٍ واضحٍ يُساوي بين الجميع دون ذكر طوائف أو أديان في باب الحقوق.
2. إصلاح التعليم والإعلام
تحديث المناهج لإبراز المشتركات، وحظر خطاب الكراهية في المنابر والقنوات.
3. عدالةٌ اجتماعيةٌ مُحايدة
توزيع الخدمات والوظائف على أساس الكفاءة والاحتياج لا على أساس الانتماء.
4. خطابٌ دينيٌّ جامع
دعم علماء يقدّمون الدين بصفته قيمةً أخلاقية سامية لا هويةً سياسية ضيّقة.
5. قوانين رادعة
سنّ تشريعات تُجرِّم التحريض الطائفي، وتضعه في خانة الخيانة العظمى لوحدة البلاد.
6. منصّات حوارٍ وطني
طاولة مستديرة دائمة تمثّل كافة المكوّنات للبتّ في القضايا الحساسة بعيداً عن الشارع.
خاتمة
إنّ "الطائفية أول ضربة معول لتدمير الوطن” ليست مجرّد استعارة بل تحذيرٌ تاريخي؛ فكلُّ أمةٍ رضيت بتشقيق نفسها على خطوط الهوية الضيقة دفعت الثمن دماً وتهجيراً وتخلّفاً. والدرس واضح: أوطانُنا لا تُصانُ بإلغاء الاختلاف، بل بإدارته تحت مظلّة عقدٍ اجتماعيٍّ عادلٍ يُقدِّمُ "المواطن” على "المذهب”. حينها فقط يصبح تنوّعُنا ثراءً، لا لعنةً، ويغدو اختلافُنا مصدرَ قوّة، لا معولَ هدم.